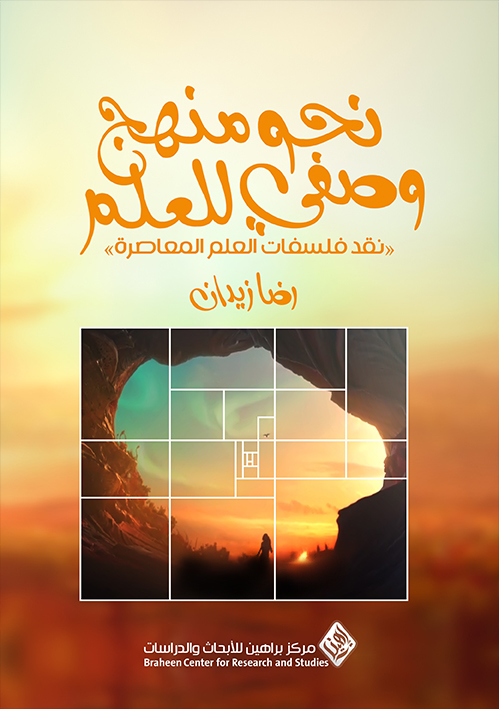ملحوظة: هذه السلسلة من كتاب (نحو منهج وصفي للعلم: نقد فلسفات العلم المعاصرة) للمزيد يرجى مراجعة الكتاب.
ب) لقد لعبت نظرية العناصر الأربعة دورا مركزيا في فيزياء أرسطو، وهم التراب والماء والهواء والنار. ولم يعتبر أرسطو العناصر أجساما أولى قائمة بذاتها، بل اعتبرها مجرد مظاهر لشيء آخر لجوهر واحد هو المادة الأولى، تنتقل من شكل لآخر حسب الكيفيات التي تصيبها؛ وتلك المظاهر توجد بالقوة داخل المادة الأولى، ثم تخرج إلى الفعل بتأثير أربع كيفيات أساسية: البرودة والسخونة واليبوسة والرطوبة. هذه الكيفيات لا نصادفها مفترقة، بل مقترنة اثنين اثنين، باستثناء اقتران البرودة والسخونة أو اليبوسة والرطوبة، لأنهما متضادان لا يمكن التقاؤهما. حينما تتعرض المادة الأولى لليبوسة والبرودة تتحول إلى تراب، وعندما تتعرض للبرودة والرطوبة تصير ماء، وحينما تلتقي السخونة والرطوبة تغدو المادة الأولى هواء، وحينما تتعرض تلك المادة للسخونة واليبوسة تصبح نارا. وبجانب العناصر الأربعة نجد عنصر الأثير، الذي من صفاته أنه غير قابل للفساد، أي خالد، ومنه تتكون الأجرام السماوية. وينتج عن ذلك أن العالم السماوي يتكون من مادة مخالفة لتلك التي يتكون منها العالم الأرضي أو عالم ما تحت القمر، وهذا يجعل حركات كل منهما مخالفة لحركات الآخر. فالحركات الطبيعية لكل منهما محددة من طرف المادة المكونة له، إذ بينما نجد حركات العالم السماوي دائرية (الشكل الدال على الكمال عند اليونانيين وغيرهم) ومنتظمة وخالدة، تبقى الحركة في عالم ما تحت القمر حركة تتجه من أعلى إلى أسفل، ومن أسفل إلى أعلى، لأن العالم الأرضي به أمكنة طبيعية، كل عنصر يشتاق إلى مكانه منها، حسب ثقله وخفته. كما أن السماء مطلق لا شيء وراءها، ويعتقد أرسطو أن الكون بكامله يوجد داخل فلك النجوم المملوء بالمادة فلا وجود لفراغات أو ثقوب. وكمثال على الترابط العضوي بين الفيزياء والفلك الأرسطيين، نشير إلى أن رأي أرسطو في الحركة يقوم على الاعتقاد بأنه في غياب دفعات آتية من السماء تبقى العناصر الأرضية ساكنة في أماكنها الطبيعية ما لم تخرجها حركة عنيفة ما عن سكونها، فالأرض نفسها ثابتة في مركزها وسط الكون، ومن المستحيل تصورها متحركة، لأن كل الأجسام في عالم ما تحت القمر تتجه نحو مركز الكون الذي هو مكانها الطبيعي، والأرض توجد حيث يوجد محلها الطبيعي، فلا شيء إذن يدعوها أن تتحرك، لأن ما تشتاق إليه كل الأجسام في عالم ما تحت القمر متحقق بالنسبة للأرض[1].
وتلعب فكرة الامتلاء دورا هاما في الفيزياء الأرسطية، إذ عليها الاعتماد في إثبات القصور الذاتي للجسم، وإن الأجسام تميل بطبعها إلى مكانها الأصلي الطبيعي لتسكن فيه. فالأجسام المادية نتيجة لقصورها الذاتي غير قادرة على أن تخرج عن سكونها تلقائيا، لأن كل حركة تقتضي محركا، ولما كان القصور الذاتي يصدق على السكون، فإن الحركة لن تستمر إلا إذا كان ثمة محرك فعله مستمر، وفي غياب هذا الفعل لا إمكان لوجود حركة مستمرة، بل يعتقد أرسطو أن ثمة ضرورات علمية تحتم على الحركة في عالم ما تحت القمر أن تكون متناهية وعابرة منها. إن امتلاء الكون نفسه وكونه لا يعرف خلاء، يشكل عائقا أمام أية حركة نتصورها مستمرة، فالأجسام المتحركة في عالم ما تحت القمر تلقى مقاومة من طرق الوسط الذي تتحرك فيه. لاحظ أن القول بمركزية الأرض للكون يقتضي أن يكون الكون متناهيا، فلا وجود لمركز أو وسط إلا في مجال محدود ومتناه أما اللامتناهي فلا مركز له[2]. لاحظ أيضا بجانب الثنائية الأرسطية بين عالم السماء وعالم الأرض فيزيائيا هناك ثنائية انفعالية، فالسماء هي الكمال والأزلية، وكل الفيزياء الأرضية مسببة بحركات الأفلاك السماوية[3]. وهذه التصورات لم تكن خاصة بطبقة نخبوية معينة، بل كانت شبه عامة، "فقد تعوّد الإنسان المتعلم، حتى لو كان تعلمه تعلما رديئا أن يرى العالم من خلال علم أرسطو المندمج في اللاهوت الكاثوليكي. فهو يتمثل حركة متحرك محددة لا بنقطة الانطلاق وآنه وسرعته، بل بزمان الوصول ومكانه الذي يقوده إليه نوع من الشوق. ويرى في حركة الأشياء الأرضية نوعا من المرض العابر الذي يبعدها عن حالتها الفسيولوجية، وهي السكون. ويعتقد أن الأرض والسماء يتقابلان تقابل الضاد، من جهة قواعد ترتيبهما، كما يتقابل القابل للفساد والفناء مع الأزلي الساكن تقابلا كليا. ويعتبر أن حركات الكرات السماوية هي مفتاح جميع الحركات الأخرى"[4]. لذلك كان من الصعب جدا تصور ميكانيكا تنطبق على السماء مثلا، أو قانونا كونيا.
هذا النظام الأرسطي قد أدى إلى مظاهر شذوذ تعذر على الكنيسة تفسيرها، وحاولت على مدى القرون تقديم تفسيرات متباينة بطرق مختلفة، ولكن مظاهر عدم الانتظام والشذوذ واضحة للعين المجردة، فها هي الكواكب مثلا تغير مسارها أمام ناظريها، مثل كوكب المريخ الذي يتوقف أو يتراجع إلى الخلف أحيانا، وكان التفسير الوحيد المقنع لنظام معروف بأن الأجرام السماوية فيه لا تغير اتجاهها، هو التفسير الذي قدمه في القرن الثاني الميلادي، عالم الفلك الإسكندري بطليموس (الذي جمع كل التعديلات والتطويرات على النظرة الأرسطية حتى عصره). حيث كان يرى أن كل كوكب من الكواكب يدور في فلك صغير مرتبط بالفلك الرئيسي. ومن ثم يحدث في أوقات معينة داخل هذا النظام، أن تتحد الأفلاك الرئيسية بالأفلاك الأصغر مما يتسبب عنه انحراف في حركة الكواكب (فلك التدوير) أو المدار الذي يدور حوله مدار آخر[5]. هذه الجهود التي قدمها بطليموس لتوفير نماذج رياضية لحركات الكواكب الملاحظة قادته إلى اقتراح كيانات افتراضية، ووضع افتراضات قائمة على البساطة (الأناقة)، مما بدا غير متوافق مع الفيزياء الأرسطية. وربما هذا قد يؤدي ببساطة إلى رفض الأفكار البطلمية، إلا أنه لم يكن هناك نظام فلكي مفيد آخر. وفي نفس الوقت يستمر الإقرار بأن النظام الحقيقي للسماء يجب أن يكون كما وصفته كوزمولوجيا أرسطو. ونتيجة ذلك كانت فصلا بين الأجزاء الرياضية والأجزاء الفيزيائية لعلم الفلك، أو فصلا للمهارة العملية للفلك والكوزمولوجيا"[6].
– بعد قرون عديدة استشعرت الدوائر العليا في المجتمع الأوروبي الحاجة إلى إصلاح التقويم الميلادي الجاري به العمل نظرا لتفاقم أخطائه وتزايدها مع الزمن (وأهم مظاهر ذلك عدم القدرة على تقدير دقيق لتاريخ عيد الفصح)، فطلب البابا نفسه من كوبرنيك (1473 – 1543) أن يتولى الإصلاح بنفسه في إطار نظريات بطليموس والملاحظات الفلكية المعمول بها، لكنه رفض الأمر برمته، لأنه يرى ضرورة إصلاح علم الفلك. لكن ليس الإصلاح المقصود لأسباب علمية، أو قل أن "الأسباب العلمية تنحصر في بعض الاعتبارات التقنية المتعلقة بعدم الضبط والدقة في حساب مواقع الأفلاك: أنه عدم ضبط يترتب عليه عدم تطابق الملاحظات الحسية مع نتائج الحساب الفلكي. وخارجا عن هذا الإلحاح الرياضي التقني، لا نعثر على أي إلحاح علمي آخر، ذلك أن أي حدث علمي جديد لم يظهر ليكذب نظام بطليموس، ويرغم علماء الفلك على إعادة بناء نظرياتهم، بل نفس الوقائع الملاحظة هي هي، ونفس تقنيات الملاحظة المتبعة منذ وقت بطليموس هي نفسها التي اعتمدها كوبرنيك، إنها الملاحظة بالعين المجردة، بل إن الكيفية التي ألف بها كوبرنيك نظامه الجديد في كتاب (دورة الأفلاك السماوية) منقولة عن الكيفية التي ألف بها بطليموس كتاب (المجسطي) حتى على مستوى ترتيب الأبواب والفصول"[7]. لكنه يختلف في جعل الشمس وسط الكون وتحريك الأرض، بل حتى في هذه المعالجة كان متأثرا بالتصورات الغائية القديمة، "فقد درس قضايا مثل: أيهما أكرم للجسم، أن يتحرك أم يكون ساكنا؟ ورأى أن من الأكرم لجسم مثل الشمس أن تكون ساكنة وأن تعطي الضوء في مركز الكون"[8]. "ويبدو أن طرح كوبرنيك لفكرة أرض تدور، لم يكن غرضا رئيسيا، بل جاء كمجرد وسيلة عارضة للمساهمة في تسهيل التنبؤ الدقيق بمواقع الكواب، أي أن الغاية منها إصلاح التقنيات المستعملة في حساب تلك المواقع"[9]. فلم يكن يقصد كوبرنيك بإصلاحه ثورة علمية ولا معرفية بأي معنى، ولم يكن يقصد بعمله أي قطع مع الفكر القديم والوسيط، فقد كان "مفكرا وفيلسوفا على طريقة قدامى الإغريق أكثر منه عالما حديثا"[10]، وهو وإن تجاوز الكوزمولوجيا البطلمية –كما يقول جورج كانجيلام– "فإنما فعل ذلك بهاجس الوفاء الأكبر لروحها، أي من أجل أن ينقذ بصورة أفضل، أي بصورة أبسط، الظواهر البصرية... بمعنى أنه من أجل أن يكون أكثر بلطمية من بطليموس جعل الثورة الكوبرنيكية ممكنة"[11]. ثم وجود المناخ المناسب أدى ذلك تدريجيا إلى تجديدات فيزيائية على يد جاليليو وكبلر ثم نيوتن.
ومع ذلك فهذا لا يقلل من قيمة النموذج الكوبرنيكي العلمية، فقد فسر بعض الظواهر التي كانت بمثابة لغزا للقدماء، من أهمها أنه ليس بالإمكان رؤية عطارد والزهرة من الأرض إلا وقت الفجر والغسق، خلافا لبقية الكواكب المعروفة. وتفسير بطليموس لذلك كان غائيا أو عضويا أو ما شئت قل، إذ يعتبر أن عطارد والزهرة "يحافظان على صحبة" الشمس على مدى رحلة الشمس حول الأرض مرة واحدة في السنة. ولكن المنظومة التي وضعها كوبرنيك تفيد بأن الأرض تدور حول الشمس مرة في السنة، ومن ثم فإن التفسير لنوعي حركة الكواكب هو ببساطة أن مداري عطارد والزهرة موجودان داخل مدار الأرض (لأنهما أقرب إلى الشمس منا) بينما مدارات المشترى والمريخ وزحل موجودة خارج مدار الأرض (أي أبعد منا عن الشمس). واستطاع كوبرنيك بفضل قبول القول بحركة الأرض أن يحسب طول الفترة الزمنية التي يستغرقها كل كوكب ليكمل مداره حول الشمس، وشكلت هذه الفترات الزمنية تتابعا متواليا ابتداء من عطارد، حيث سنته هي الأقصر وانتهاء بزحل حيث السنة الأطول[12]. أما القيمة الأكبر أو التأثير الأكبر لتصور مركزية الشمس الجديد فكان خفيا إلى حد كبير، أو تفجر تدريجيا بعوامل مساعدة، وهو التغيير التدريجي في صورة العالم الدينية الأرسطية (التي تسلم بمركزية الأرض) لتصبح صورة عالم مستقلة عقلانية تعتمد على التجريب. يقول جون ديوي: "كان انهيار فكرة إن الأرض مركز الكون من أهم إنجازات العلم الحديث. فحين اختفت فكرة المركز المحدد الثابت تلاشت معها فكرة (الكون المطلق) المحاط بحدود سماوية. كان (المنتهى) أو (المتناهي) بالنسبة للفكر اليوناني هو (الكامل) بسبب منهجه المعرفي الذي خضع لمعايير جمالية"[13]. إن ما فعله كوبرنيك سواء رأى واقعية فيزيائية لدوران الأرض ومركزية الشمس أم كان الأمر مجرد فرض نظري لتسهيل الحسابات"ليس فقط وضع الأرض في حالة حركة ضد كل تعاليم الفيزياء الأرسطية والكتاب المقدس والحس العام، بل أيضا قيام موقفه على ما يعتبره معظم معاصريه أسسا غير مشروعة. فوفقا لمعظم معاصريه، هذه الأنواع من المزاعم تتطلب تفسيرات أو تبريرات فلسفية أو فيزيائية، لكن كوبرنيك قدم فقط ججج رياضية مجردة تماما"[14]. وهذا يعني إدراك جزئي لأن الرياضيات أداة مفيدة لتأسيس الواقع، الواقع السماوي على الأقل حينها.
جدير بالذكر أن كتاب كوبرنيك دورة الأفلاك السماوية (De Revolutionibus Orbium Coelestium) لم تهاجمه الكنيسة الكاثوليكية بعد صدوره، والظاهر أن من أسباب ذلك هو أن الكنيسة لم تنظر إلى الفكرة كحقيقة مادية، وإنما كطريقة حسابية أبسط، "فمن الحقائق أن معظم من كان على دراية بكتاب كوبرنيك اعتقد أن المؤلف قصد فقط تمثيل فلكا أداتيا"[15]. ومن الطبيعي ألا يستقبله الناس بنقاش أو بتفاعل معتبر، لكن الحركة البروتستانتية الأروبية قد هاجمت الكتاب على طول الخط، فقد أعلن مارتن لوثر: إن الناس تستمع إلى فلكي مدع، يبذل قصارى جهده ليثبت أن الارض هي التي تدور وليس أفلاك السماوات، أو القبة الزرقاء أو الشمس والقمر. وهي رغبة غبية تستهدف قبل علم الفلك رأسا على عقب"[16]. وما لبثت الكنيسة الكاثوليكية أن أدركت خطورة نتائجه وأنكرته عام 1616 (ولم تخرجه من القائمة المحظورة حتى عام 1835)، أي بعد عقود من صدور الكتاب (1543). وكان لتحمس الفيلسوف الإيطالي جوردانو برونو لفكرة مركزية الشمس دورا مهما لموقف الكنيسة من الكتاب، إذ أن برونو قد اتهم بالهرطقة من الكنيسة الكاثوليكية لآرائه الدينية المعارضة تماما للكنيسة، ووصم الكنيسة لآرائه إجمالا ومن ثم حرقه أدان بشدة النظرية الفلكية، أو أن الكنيسة أدانت آرائه اللاهوتية والفلكية معا، ففي هذا خلاف بين المؤرخين[17].
– كبلر (1571 – 1630): من أهم الأفكار التي قدمها كبلر –المنظّر الفلكي الكبير– فيما يتعلق بموضوعنا فكرة أن الكون آلة، فقد استعان بنتائج أرصاد كوبرنيك روأيه أن الكواكب تتحرك في مدارتها بسرعة أبطأ كلما ابتعدت عن الشمس، وذهب إلى أنها تواصل حركتها في مداراتها بفعل قوة تصلها من الشمس وتدفعها إلى الأمام، وأكد على أن هذه القوة أو الطاقة تصبح أقل كلما كانت أبعد عن الشمس وتكون لديها القدرة فقط لدفع الكواكب الأبعد مسافة ببطء أكثر، وحفزته إلى هذه الفكرة جزئيا أعمال وليام جيلبرت في المغناطيسية، وتمثل فكرة كبلر هذه خطوة مهمة، لأنها أوحت بأن ثمة سببا فيزيقيا لحركة الكواكب، وليس الملائكة أو قوة روحية فيها، وقد قال كبلر: "هدفي... أن أبين أن ماكينة الكون ليست مثل كائن يحيا ويتحرك بقوة غيبية، بل إنها مثل الساعة"[18]. وأرسل كيبلر نسخا من كتابه إلى كثير من مفكري عصره، وعلى رأسهم جاليليو. وساعد على ذلك أفكاره الجديدة اللاحقة، فلا غرابة أن عقلية مثل كبلر يدهشها لغز مدار المريخ، وحاول في أول الأمر تجربة مدار معادل (لكن لا يزال دائريا) بحيث يصبح المريخ أقرب إلى الشمس في أحد نصفي الدائرة عنه في النصف الآخر، وأفاد هذا بدرجة ما لاكتشاف أن المريخ يتحرك في أحد النصفين أسرع (النصف الأقرب إلى الشمس)، ومع الوقت اتخذ كبلر خطوة كانت مهمة جدا وقتذاك، إذ أجرى بعضا من حساباته من منظور مراقب يرصد المريخ وينظر إلى مدار الارض، وهذه قفزة كبرى من حيث المفاهيم، وتمثل إرهاصا للفكرة القائلة أن جميع الحركات نسبية. توصل كبلر في العام 1602 إلى ما يعرف الآن بقانون كبلر الثاني، بأن ثمة خطا افتراضيا يصل بين الشمس وكوكب يدور في فلكه، وأن الشمس تقطع مساحات متساوية في أوقات متساوية، وهذه طريقة محددة توضح أن الكوكب يكون أسرع حركة كلما كان أقرب إلى الشمس، نظرا لأن خط نصف القطر الأقصر لا بد أن يمتد عبر زاوية أكبر ليشمل المنطقة ذاتها التي يمتد على طولها خط نصف القطر الأطول عند حركته عبر زاوية أصغر، وبعد هذا الاكتشاف فقط تحقق كبلر من أن شكل المدار هو بالفعل شكل إهليليجي. وفي عام 1605 شغله عمل آخر، وتوصل إلى ما يعرف الآن بقانون كبلر الأول، ويفيد بأن كل كوكب يدور في مداره الإهليليجي حول الشمس حيث تحتل الشمس البؤرتين (البؤرة نفسها لكل من التصورين) للمداري الإهليليجي. وهكذا أطاح كبلر بقانونيه الحاجة إلى القول بفلك التدوير ونقاط التقابل وغير ذلك من تعقيدات قديمة اشتملت عليها النماذج السابقة عن الكون[19]. لأن فلك التدوير مفترض أصلا لعدم إسقاط النظرة الأرسطية لدائرية المدارات.
– أما جاليليو (1564 – 1642) فهو أول من صنع تلسكوبا فلكيا ووجه نحو القمر[20]، وبهذه الآلة (خصوصا بعد تطويرها لتصبح بقوة تكبير عشرين مرة) اكتشف الأقمار الأربعة الأسطع ضوءا والأكبر حجما للمشتري في مطلع عام 1610. وهذا الاكتشاف برهان على دقة نموذج كوبرنيك (الذي ناصره جاليليو بشدة، وإن كان اهتمامه به في أول الأمر كان من حيث علم الحركة المجردة والميكانيكا الأرضية لا السماوية)، فمن الحجج المضادة التي استخدمها الأرسطيون أنه إذا كان القمر يتحرك في مدار حول كوكب الأرض فلن يكون في إمكان الأرض أن تتحرك في مدار حول الشمس في الوقت نفسه، ذلك لأن الأرض والقمر سيبتعد أحدهما عن الآخر. ولكن بهذا الكشف وضح جاليليو أن أقمار المشتري تدور حوله وهي نفسها تدور في مدار حول شيء، أيا كان هذا الشيء هو الأرض أم الشمس لا يهم، فالحجة سليمة. وأوضح جاليليو أن بالإمكان أن يبقى القمر التابع لكوكب الأرض في مدراه حول الأرض حتى مع حركة الأرض. واكتشف بالتليسكوب أيضا أن درب التبانة مؤلف من كم هائل من النجوم المفردة، وأن سطح القمر ليس كرة منبسطة سوية تماما (كما يعتقد الأرسطيون) بل تتخله حفر، وعلى سطحه سلاسل جبلية تمتد عدة كيلو مترات[21]. وهذا النفي للكروية التامة للقمر يعارض تماما النظرة السائدة آنذاك عن أن الأجرام السماوية دوائر كاملة. وهذا مؤشر على الأقل على أن المادة السماوية هي هي المادة الأرضية، وأن السماء ليست متفردة في جوهرها، وإذا كان الأمر كذلك "فالنتيجة الواضحة هي: إذا كان القمر باستطاعته أن يدور حول الأرض، رغم أنه مكوّن من مقادير كبيرة من التراب والماء، فلماذا لا يمكن للأرض نفسها أن تدور حول الشمس؟"[22]. لا شيء من ذلك أقنع الأرسطيين، الذين رفضوا قبول ما رأتهم أعينهم عبر التلسكوب، وبعضهم رفض أصلا قبول دعوة جاليليو للنظر إليه، "وعمد جاليليو نفسه إلى اختبار هذا الاحتمال بأن رصد مئات الأجسام من خلال التلسكوب ثم يغلقه لكلي يتبين إن كانت الآلة تفعل أي شيء آخر غير التكبير، وخلص إلى نتيجة محددة وهي أن ما يراه عبر الآلة حقيقي"[23]، ومع ذلك "لم يكن خصوم جاليليو الذين ارتابوا في اكتشافاته جميعهم بلهاء وضيقي الافق"، فيكفي لتبرير موقفهم أن تكبير اشياء أرضية من خلال التلسكوب مختلف عن النظر إلى السماء والتنقيب فيها، لأن الحالة الأولى يمكن معرفة "الفرق بين الموضوع المرئي [الباخرة مثلا] وبين التشويهات الناجمة عن التلسكوب بسبب ألفة الملاحظ لمظهر الباخرة"، أما المنقب في السماء فهو "يقصد أن يجد فيها أشياء لا يعرفها"، و"مما له دلالة في هذا الصدد أن خريطة سطح القمر التي رسمها جاليليو انطلاقا مما رآه بواسطة التلسكوب، تتضمن بعض الفوهات التي لا توجد فيه في الواقع. فقد تكون هذه الفوهات تشويهات ناتجة عن كيفية عمل تلسلكوبات جاليليو التي كانت بعيدة عن الكمال"[24].
رغم الدعم للنموذج الكوبرنيكي حرص جاليليو أشد الحرص على ألا يعلن تأييده لنموذج كوبرنيك، خشية من مصير برونو، وترك التلسكوب نفسه يتحدث للقساوسة المشهود لهم بالمعرفة الذي جاءوا رسميا لاختبار آلة جاليليو وليس آثار ملاحظاته، وأقروا بالفعل أن درب التبانة به عدد هائل من النجوم وأن سطح القمر غير مستو وأن المشتري له أربعة أقمار وغير ذلك.
أثر جاليليو في حياته تأثيرا كبيرا على تطبيق المنهج العلمي، ويظهر ذلك من حواراته، ففي حوار دار بين الأساتذة في جامعة بيزا عن التكثف، دافع أحد زملاء جاليليو عن أن الثلج يجب النظر إليه باعتباره شكلا من أشكال تكثف الماء، مادام أنه صلب والماء سائلا، ولكن جاليليو من ناحية أخرى قال: مادام أن الثلج يطفو على سطح الماء، فلا بد أنه أخف وزنا من الماء، ومن ثم أقل كثافة. فقال زميله: ليس كذلك، فالثلج يطفو لأن له قاعدة عريضة ومسطحة تحول دون دفعه إلى أسفل في الماء. ورفض جاليليو الحجة وفندها بأن أوضح أن الثلج لو شددته إلى أسفل تحت الماء ثم تركته فإن شكله العريض والمسطح لن يحول دون اندفاعه صاعدا إلى أعلى وسط الماء. ثم جرى جدال لمعرفة ما إذا كان من الممكن جعل الأجسام الصلبة المصنوعة من مادة واحدة (ومن ثم ذات كثافة واحدة) تغوص أو تصعد في الماء إذا ما غيرنا أشكالها فقط، وتمثلت حصيلة الحوار في أن جاليليو تحدى خصمه الرئيسي ليبين لهم بالتجربة إذا ما كانت الأجسام ذات التكوين المتماثل ولكنها مختلفة الأشكال، وتغوص تماما منذ البداية في الماء. ويعتمد علوها على السطح أو غرقها على طبيعة شكل كل منها. وجرت التجربة نهارا أمام الجميع وأثبت جاليليو فشل منافسه[25]. والتطبيق التجريبي والاعتماد على الاختبار بهذا الشكل لم يكن شائعا بهذا الشكل أمام المدرسيين، فضلا عن دمج الصورة الرياضية للعالم بالفلسفة الطبيعية، "وطبيعة هذا الدمج بين العلوم والرياضيات كان مشجعا للاهتمام ببعض المعايير العلمية للمعرفة"[26]. يقول جاليليو: "إن كتاب الكون لن يفهمه المرء ما لم يتعلم أولا كيف يفهم اللغة ويفهم الأبجدية المكتوب بها. إنه مكتوب بلغة الرياضيات، وأحرفه هي المثلثات، والدوائر، وغير ذلك من أشكال هندسية، وإنه من دونها سيكون من المستحيل بشريا فهم كلمة واحدة منه، ومن دونها سيجول المرء وسط متاهة مظلمة"[27]. ولعل إسهامه الأعظم للعلم، كما اقترح جاري هاتفيلد، هو تمثيله على فائدة ونجاح المقاربة الرياضية للطبيعة[28]، "ويبدو من الواضح إلى حد ما أن الممارسون الرياضيون لعبوا دورا مهما في تأسيس المنهج العلمي"، وإن كانت "الطبيعة الدقيقة لدور العلوم الرياضية في تشكيل المنهج التجريبي لم تثبت حتى الآن في البحث التاريخي"[29].
ولا شك أن رجل بشهرة جاليليو قد أثر في حضور هذا النمط من أنماط الاستدلال، خصوصا بأتباعه الذين تابعوا عمله في الفيزياء الرياضية، مثل بونافنتورا كافاليري (Bonaventura Cavalieri) (1598 – 1647)، وإيفانجيلستا تورشيللي (Evangelista Torricelli) (1608 – 1647). بل وضع جاليليو نص الكتاب المقدس أمام العلم صراحة، ففي رسالة جاليليو إلى كرستينا الدوقة العظيمة التي كتبها تحديدا عام 1614 وهي موثقة بوضوح قال: "أومن بأن الشمس تحتل المركز وسط الأجرام السماوية التي تدور في أفلاكها ولا تغير مكانها. وأومن كذلك بأن كوكب الأرض يدور حول نفسه ويتحرك في مداره حول الشمس" ثم يقول معلقا على قلق كرستينا من تعارض ذلك مع نص الكتاب المقدس: "عندما يثار خلاف في الرأي بشأن ظواهر طبيعية، يتعين علينا حينئذ ألا نبدأ بمرجعية النص المكتوب، بل بمرجعية التجربة الحسية والبراهين الضرورية التي تثبت صحة ذلك"[30]. وبالطبع كانت محاكمته الشهيرة من أكثر المشاهد التي أثرت في الصورة المزيفة لتعارض العلم والدين. لكن الثابت فيها أنها كانت بداية "صدام بين روح الاستقراء وروح القياس. فالمؤمنون بالقياس من حيث هو طريق الوصول إلى المعرفة، مضطرون أن يجدوا مقدماتهم في مكان ما، وهم يجدونها عادة في الكتب المقدسة... ولما كان القياس من حيث هو وسيلة الحصول على المعرفة يتداعى بنيانه إذا أُلقي الشك على مقدماته، لذلك كان لا بد أن يحنق المؤمنون بالقياس على من يشك في صحة الكتب المقدسة"[31].
– نيوتن (1642– 1727): بطبيعة الحال استفاد نيوتن –الذي يعد في نظر الكثيرين أعظم عالم على الإطلاق– من إسهامات الأسماء السابقة وغيرهم، وكان صاحب إسهامات كبيرة للغاية في فروع علمية مختلفة، لكن ما يهم موضوعنا هو أن افتراض القانون الأول للحركة "قد ألغى ضرورة افتراض أنه لابد من وجود قوة دافعة أو جاذبة للكواكب لتتحرك في مساراتها"[32]. فقد طبق نيوتن تفسير دوران القمر حول الأرض على دوران الكواكب حول الشمس، فلو افترضنا بناء على القانون الأول للحركة أن القمر سوف يستمر في مساره إلى الأبد في خط مستقيم وبنفس سرعته حتى ولو لم تكن هناك قوة على الإطلاق تؤثر عليه سوف نرى عندئذ أن الشيء الوحيد المطلوب لجعله يتحرك ويدور حول الأرض هو قوة تعمل خلال نصف القطر من القمر إلى مركز محوره، أي الأرض. وليس من الضروري أن تكون هناك قوة مماس، مادامت حركة القمر المستمرة يمكن تفسيرها بدون أية قوة، والشيء الوحيد المطلوب لكي تفسره القوة هو تغيير الاتجاه من الخط المستقيم. أدرك نيوتن ذلك بعبقريته واستطاع أن يستغني عن قوة التماس، وراح يبحث عن قوة نصف قطرية. ووجد ضالته في "قانون الجاذبية" التي كانت فكرة غير واضحة قبله لكنها كانت موجودة ابتكرها علماء سابقون. حيث أن قوة الجاذبية بين جسمين تتناسب مباشرة مع محصلة كتلتيهما، وهي تتناسب عكسيا مع مربع المسافة (ٌقانون التربيع العكسي). ولكي يحاول تطبيق هذه الصيغة على القمر كان عليه أن يعرف المسافة بين الأرض والكتل الموجودة فيها، وبين القمر. واستغل هنا التقديرات التي كان قد قام بها بالفعل، وكانت مشكلته هي حساب حركات القمر، وهل تتق هذه الحركات المحسوبة مع الحركات التي نشاهدها. وكان هناك اختلاف 12% بين الحركات المحسوبة والحركات الفعلية، لكنه عاد بعد ذلك لدراسة المشكلة باستخدام تقدير جديد لمسافة القمر، واتفقت حساباته مع الوقائع الملاحظة[33]. وبالمثل فسر حركات الكواكب حول الشمس بنفس القانون، ونجح في تفسير ظواهر كثيرة جدا، منها اضطراب الكواكب في حركتها المدارية بقوة غير القوة التي تسبب دورانها المنتظم، ومثل ظواهر المد والحذر. والنقطة الهامة أيضا أن قوانين كبلر الثلاثة اتضح أنها نتائج لقوانين الجاذبية، أي أن تفسير قانون الجاذبية لموقع المريخ في السماء في لحظة معينة هو مثال على قانون عام.
ومن المعلوم أن نيوتن كان متدينا بشدة، ورأى البعد الإلهي في حركة الكواكب ودورانها حول الشمس بانتظام، فتصور أن الله خلق العالم مثل الآلة لتعمل على هذا النحو، وأدرك أن أي تغير في تلك المسارات من حيث المسافة أو السرعة (مما يؤثر على المسار الأرضي) يعني انعدام الحياة على الأرض، وأشار نيوتن في كتاباته إلى الجانب الغائي في دراسة الطبيعة، وكان من المعتاد ذكر ذلك أصلا. بل استند نيوتن إلى ذلك الجانب الغائي كتفسير علمي للشذوات أو الانحرافات المعينة التي كان يلاحظها ولا يمكن تفسيرها بقانون الجاذبية، فالحركات الفعلية كانت تنحرف انحرافا بسيطا جدا عن الحسابات القانونية. لكن نيوتن كان يفترض أن تراكم تلك الانحرافات سيؤدي إلى انهيار النظام الشمسي، لذلك رأى أن الله يتدخل من حين لآخر ويعيد الكواكب المنحرفة إلى مسارها الطبيعي. هذا الاستناد الغائي رفضه لابلاس (1719 – 1827) وبين أن تلك الانحرافات ليست تراكمية كما افترض نيوتن، وإنما هي تصحح نفسها بعد فترة طويلة كافية من الزمان فتلغي بعضها بعضا. وهذا المثال بات الأيقونة الأكبر لرفض أي تفسير غائي للعمليات الطبيعية، وإذا كان رد الفعل على النويتنية –المخالف تماما لمقصد نيوتن– هو إنكار الغائية كتفسير علمي إلا عملية الخلق الإلهية نفسها؛ فإن رد الفعل على الداروينية كان إنكار الغائية على الإطلاق.
هذا التصور الميكانيكي للطبيعة في القرن السابع عشر أصبح تدريجيا تصورا عاما عند القطاع الأعم من الناس، لأن كتاب نيوتن "المبادئ الأساسية لرياضيات الفلسفة الطبيعية" ("ذروة نمذجة صورة العالم رياضيا"[34]) قد اشتهر شهرة منقطعة النظير، وكتب عنه صديقه جون لوك: أوضح السيد نيوتن، الذي لا يدانيه أحد، كيف أن الرياضيات عند تطبيقها على بعض جوانب الطبيعة، وربما على المبادئ التي تبررها حقائق الأمور، يمكن أن تحملنا على طريق معرفة بعض ما أسميه المجالات المميزة للكون العصية على الفهم"[35]. ومن ثم أبطل تدريجيا معظم التصورات السحرية أو القوى في المادة، "وعندما صرح ديكارت (1650 – 1696) بأنه (لا توجد بالأحجار والنباتات قوة خفية ومتوارية عنا... لا شيء يوجد بالطبيعة إلا ويرد إلى أسباب جسيمة محضة، لا دخل للأرواح أو الأفكار فيها) فإنه كان ينوب عن الجميع وينطق بلسان حال فلسفة العلم السائدة"[36]. فالمادة التي يتكون العالم منها لا تتضمن خصائص أخرى غير تلك البادية للحدس العقلي، أي الامتداد، لذا يجب تصورها على نحو يفهمه ويقره العقل الطبيعي النير، ذلك العقل الذي يهتدي بالمبادئ الرياضية. فالمادة امتداد هندسي يملأ المكان ويشغله، بحيث لا يبقى فيه خلاء أو فراغ. ومن الواضح أنه لا يمكن نسبة أي جوهرية غامضة سحرية مفترضة إلى ذلك الامتداد، وهذا ما يجعنا قادرين على تسخيرها ونكون سادة عليها[37]. ويمكن أن نستثني هنا المادة العضوية، فلقد استمر خلال تلك الفترة النظر إلى المادة العضوية بنوع ما من الاختلاف (باستثناء فلسفة ديكارت التي تجعل الحيوان آلة، والجسم الإنساني على الأرجح، أي أن فلسفة ديكارت الآلية كانت أوسع ميكانيكة من النيوتنية، ولا شك أن لكتاب هارفي "حركة القلب" عام 1628 الداعي لسلطة التجربة والمقارن لجسم الحيوان بالإنسان تأثيرا كبيرا على ديكارت في هذا الجانب) حتى جاء داروين.
[1] سالم يفوت، مرجع سابق، ص11
[2] المرجع السابق، ص12
[3] ومن هنا لم يكن يُنظر للتنجيم خلال فترات طويلة من الإنسانية إلا بتبجيل وتصديق، واستمر التصديق حتى القرن السابع عشر.
[4] جورج كانجيلام، دراسات في تاريخ العلوم وفلستها، المنظمة العربية للترجمة، ترجمة: محمد بن ساسي، ص75-76
[5] جيمس بيرك، عندما تغير العالم، عالم المعرفة، ترجمة ليلى الجبالي، ص139
[6] John Henry (2008), P. 15
[7] سالم يفوت، مرجع سابق، ص21
[8] فيليب فرانك، فلسفة العلم: الصلة بين العلم والفلسفة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ترجمة علي علي ناصف، ص136
[9] سالم يفوت، مرجع سابق، ص22
[10] جون غريبين، تاريخ العلم ج1، عالم المعرفة، ترجمة شوقي جلال، ص32
[11] جورج كانجيلام، مرجع سابق، ص63
[12] جون غريبين، مرجع سابق، ص37
[13] جون ديوي، إعادة البناء في الفلسفة، المركز القومي للترجمة، ترجمة أحمد الأنصاري، ص83
[14] John Henry (2008), P. 17
[15] John Henry (2008), P. 18
[16] جيمس بيرك، مرجع سابق، ص141
[17] Adam Frank, The Constant Fire: Beyond the Science vs. Religion Debate, University of California Press, 2009
[18] جون غريبين، مرجع سابق، ص87
[19] المرجع السابق، ص93
[20] يذكر التاريخ أن خلال 24 ساعة صنع جاليليو تلسكوبا أفضل من أي تلسكوب آخر عرف في زمنه، وإذا كان التلسكوب الهولندي الذي رآه قبل هذا اليوم استخدم فيه عدستين محدبتين، بحيث ترى الصورة مقلوبة، استخدم جاليليو عدسة مقعرة وأخرى محدبة، بحيث ترى الصورة في وضعها المعتدل العادي. انظر: تاريخ العلم، مرجع سابق، ص123
[21] المرجع السابق، ص124
[22] John Henry (2008), P. 25
[23] غريبين، مرجع سابق، ص127
[24] آلان شالمرز، نظريات العلم، دار توبقال، ترجمة الحسين سحبان وفؤاد الصفا، ص79
[25] غريبين، مرجع سابق، ص129
[26] Peter Dear (2001), P. 77
[27] المرجع السابق، ص134
[28] John Henry (2008), P. 25
[29] المرجع السابق، ص31
[30] غريبين، مرجع سابق، ص130
[31] برتراند راسل، مرجع سابق، ص29
[32] ولتر ستيس، الدين والعقل الحديث، مكتبة مدبولي، ترجمة وتعليق وتقديم: إمام عبد الفتاح إمام. ص84
[33] المرجع السابق، ص86-87
[34] John Henry (2008), P. 28
[35] غريبين، مرجع سابق، ص239
[36] سالم يفوت، مرجع سابق، ص63
[37] المرجع السابق، ص64